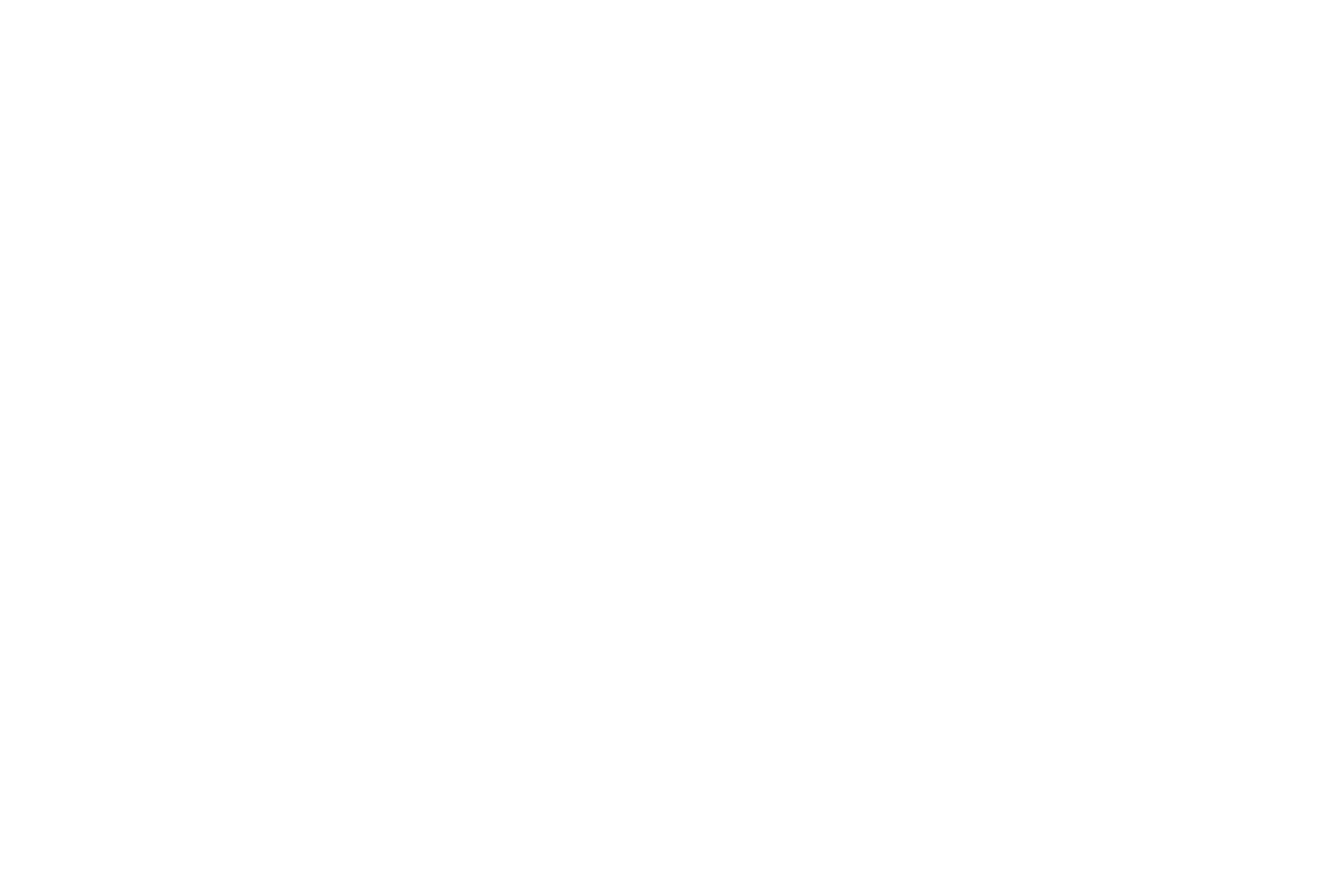من المهم تلمُّس بعض ملامح الحراك الاجتماعي في مصر كأنموذج لدول الربيع العربي، والعمل على وضع أسس جديدة للحراك بنية التغيير، وبِناءً على الدراسة الدقيقة للبنى الاجتماعية والمتغيرات السياسية، فإذا كان الحراك الشعبي يحتاج إلى رصيده المجتمعي أو ما يسميه علماء الاجتماع “برأس المال الاجتماعي” من مجموعات وقيادات وأموال وعلاقات وتكتلات بشرية، فسنحاول هنا تحديد بعض تلك المرتكزات التي تنطلق من الواقع المصري؛ وإن كانت تصلح كذلك لبقية دول الربيع العربي مع مراعاة خصوصية كل تجربة بطبيعة الحال.
وقبل أن نتناول مفهوم رأس المال الاجتماعي وكيفية الإفادة منه لتحقيق الحراك السياسي والاجتماعي المنشود؛ لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ أي نظام ديكتاتوري سلطوي توصَّل إلى السلطة بالبطش؛ سيتطلب فترة استتباب قبل أن يشعر بالراحة والاسترخاء، ولذة النصر في مواجهة خصومه وأعدائه، لأنَّه أعلم الناس بهم وبنقاط ضعفهم وهو أقدر على قمعهم في حال نشوته وقمة سطوته واستنفاره في حموة البدايات، وقد يحدث هذا الاسترخاء في الجيل التالي، الذي سيعمل كنسخة من نفس النظام. وفي هذا السياق يعمد إلى تفتيت رأس المال الاجتماعي للفئات الرافضة له؛ من منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية إلى مؤسسات اقتصادية ودعوية ودعائية، فضلًا عن الأحزاب السياسية بطبيعة الحال.
يمثل رأس المال الاجتماعي: “مجموعة القيم والمفاهيم والمعايير التي تشكل ثوابت الثقافة العامة لجماعة إنسانية، أو ما يمكن تسميته بالعقل الجمعي، وهو مجموعة من الثوابت التي يشترك فيها الناس في بلد واحد، كأساس للتفاهم والتشارك في الأعمال والأفكار والمال فيما بينهم، لتخلق نوعًا من الفعل الجمعي المنسجم، الذي يمكّن النظام الاجتماعي من العمل بكفاءة أكبر”.
لقد كانت تأسيسات ابن خلدون في مقدمته عن العرب وغيرهم من الشعوب ملهمة في إبراز العلاقة بين السياسة والاجتماع والاقتصاد بمفهومه التنموي، ونسج على منواله المفكرون الغربيون بعد عصر النهضة الغربي، إذ ركزوا على المميزات الثقافية للشعوب الأوروبية وتنقيح أو نفي عيوبها وأخطرها الخضوع لسلطان الكنيسة ورجال الدين.
وقد شاع في كتابات المنظرين والمفكرين في علم الاجتماع؛ كفرنسيس فوكوياما وغيره الربط بين رأس المال الاجتماعي والحراك الاقتصادي، أو العلاقة الجدلية بين الثقافة والاقتصاد؛ وأيهما يؤثر في الآخر.
ثُمَّ توجهت كتابات كثير من المفكرين -وإن كان متأخرًا- إلى أهمية العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والعمل السياسي أو الديمقراطية، وكان من أبرز من تناولوا هذه القضية المفكر الفرنسي “ألكسيس توكفيل” في كتاباته التي دونها في القرن التاسع عشر، وسار على دربه كثير من الباحثين، ومنهم “بوتنام” المهتم بالتطور الديمقراطي في الدول السلطوية، إذ يرى أنَّ مفهوم رأس المال الاجتماعي يقدم أداة تحليلية مهمة لتحقيق الديمقراطية ومناقشة العمل والتغيير السياسي!
ويرى منتقدو بوتنام أنَّ رصيد المجتمع من رأس المال الاجتماعي الذي استطاعت مؤسسات المجتمع المدني تكوينه في بعض البلدان؛ لم يحقق أهداف المجتمع دائمًا، بل على العكس أدى إلى عزل من ينتمون إليها عن باقي المجتمع وكان أبرزها تلك التي تقوم على أساس ديني، حيث ركزت على ولاءاتها الضيقة وساهمت في توسيع الفجوة بينها وبين المجتمع.
وقد أشار بعض العلماء في تقعيداتهم للسياسة الشرعية إلى ما يشبه رأس المال الاجتماعي، فنجد أنَّ إمامًا مفكرًا “كالجويني” يناقش في كتابه “غياث الأمم” أهم طرح سياسي تقريبًا في العلوم السنية، إذ افترض تصورًا قريبًا من -رأس المال الاجتماعي- وهم رموز المجتمع من العلماء والقيادات الاجتماعية أو من أسماهم “بالمتبوعين المطاعين أو أنموذج أهل الحل والعقد، وذلك في حال شغور الزمان عن إمام. وقد حاول الجويني تجنيب الأمة الوقوع في الفوضى بالانضواء تحت لواء الحاكم الذي يحقق وظيفة الإمامة، ما دامت انتظمت أمورها سياسيًّا ومنهجيًّا حتى مع تحمل بعض صور الفساد.
فإن وقع الفساد والاستبداد وساد الخلل المنهجي فهو يدعو في هذه الحالة إلى الفوضى البناءة وهي -في مفهومه- أفضل من الإمام الذي يُعمل نقيض الإمامة، إذ قال: (وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل، أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين).
وبِناءً عليه لا بُدَّ أن تكون الفوضى مقصودة وبفعل فاعل وهم المصلحون أنفسهم، أو قادة التغيير الذين سيعملون على إدارة رأس المال الاجتماعي بشريًّا وماديًّا ومؤسسيًّا ومجموعة العلاقات بينها، لمنع أو تقليل المفاسد، ودعم المصالح العامة، وذلك بإدارة هذه الفوضى كذلك، فمفاسدها أقل من المفاسد المنظمة!
ومن المعلوم من التاريخ السياسي وواقع المجتمعات بالضرورة؛ أنَّ التحولات الكبرى في أي أمة لا بُدَّ أن تعاني الفوضى طالت أم قصرت، لكن الجويني افترض التغلب على الفوضى النظامية المفسدة بالفوضى المصلحة.
وفي المقابل تروج الأنظمة المستبدة للاستقرار التسلطي بدعوى “الأمن والأمان” ليستتب لها الأمر حتى لو مارست هي العنف السلطوي بشكل يطال كافة شرائح المجتمع أو يخص فئة منها.
ولكي يتم هذا التوجه فلا بُدَّ من تفتيت الوحدة المجتمعية بشيطنة الفئات الأخطر على النظام ليمكن استئصالها أو اضطهادها، وذلك بإشاعة المناخ الشعبوي عبر الفوضى النفسية والفكرية، وهذا ما يفسر حالة الهشاشة المجتمعية المتعمدة، التي تطيل عمر النظام في الحقيقة، فغنى عن البيان أنَّ ثراء المجتمع بالكفاءات يُعدُّ مؤشرًا على صحوته وقوته وحياته.
لا ينبغي لقوى التغيير محاولة استرضاء الفاعلين في السلطة أو المغيبين بفعل ذلك الطرح الشعبوي، فبينما تحاول علاج نقائصها بصمت؛ يجب أن تعمل على كسب مساحة حقيقية وسط المجتمع وادخار رأس مالها الاجتماعي مرة أخرى، وتعويض غياب مؤسساتها بصور أخرى غير رسمية!
ولا بُدَّ من الرهان على تناقضات النظام بمقتضى نظرية الديالكتيك لهيجل مع عدم التسليم بكل مفرداتها؛ ومثال ذلك في مصر هو تلك التناقضات الفجة الناجمة عن الفجوة بين الشعارات الجوفاء التي يرفعها النظام وبين نتائجها المؤلمة في واقع الناس؛ وبقدر ما تكون الفجوة بين الشعارات والإنجاز الحقيقي أو بين الادعاءات والحقائق؛ بقدر ما يكون التمزق وشدة الصراع المتمخض عنها وسرعته، وبقدر ما تضيق تلك الفجوة وتتوفر معايش الناس والرفاه، بقدر ما تطول أعمار تلك الأنظمة وتزداد سطوتها على المجتمع!
فشعارات مثل: “الجمهورية الجديدة” و”مصر العظمى” و”قناة السويس الجديدة”، بالإضافة إلى العوائد والمدخولات الهائلة المتخيلة منها، والإنجازات الموهومة التي يروج لها إعلام النظام المصري منذ عشْر سنوات، يناقضها الانهيار السريع المتتالي والمستمر على كل الأصعدة في مكانة مصر السياسية ووضعها الاقتصادي والاجتماعي.
كما لا بُدَّ أن تتغير طبيعة التنظيمات والتشكيلات أو التكوينات المجتمعية والسياسية الرافضة له، بتغيير بعض مفاهيمها ومنطلقاتها الفكرية، وتجديد تجمعاتها وتعددها بصور متباينة، فلا يمكن اعتماد الهياكل الهرمية التنظيمية الكبيرة كسابق عهدها ولا بُدَّ من الاستعاضة عنها بخلايا صغيرة محدودة لا تزيد إحداها عن عشَرة أفراد ولا علاقة لها بغيرها، كما يجب أن تعيد قوى التغيير تموضعها حسب تغير الثغرات المجتمعية التي تنتج عن سياسات النظام الجديد اقتصاديًّا وسياسيًّا؛ بمعنى محاولة اكتساب المرونة الضرورية للتكيف والتحور مع المعطيات الجديدة دون جمود على الهياكل القديمة!
لا بُدَّ أن تقيم نظامها القيادي والإداري بما يفرق بين طبقاته ومستوياته المتعددة، حيث يكون هناك طبقة مسؤولة عن التنظيم وأخرى للتخطيط وثالثة للإدارة ورابعة للعمليات السياسية التنفيذية. كما ينبغي أن يُسمح بالتداول والتعدد داخل هذه التنظيمات أو التكتلات الحركية والشعبية؛ فيمكن أن يتولى قيادة التنظيم أو التجمع قيادة بمسؤوليات ومهمات محددة، على أن تُحاسب عليها وتسلمها بعد سنتين على سبيل المثال، كما توجد ضرورة لتقنين فكرة إقالة القيادة عند الإخفاق إن لم تستقل من تلقاء نفسها.
وإذا كان تفكيك البنية الاجتماعية لصالح سيطرة السلطة قد بدأ في عهد محمد للقضاء على التكتلات القبلية في كل أنحاء مصر بما تعنيه من قوة وثروة ودور إداري وقضاء عرفي في مناطقها، وبالتالي ما قد تمثله من دور سياسي محتمل، أو على الأقل مشاركة في استفراد السلطة المركزية في هذه العناصر مجتمعة بما يعني توهين قدرتها، ولذا فإنَّه من المهم محاولة إعادة تكوين تكتلات مركزية في المحافظات الكبرى أو على هوامشها؛ وذلك من خلال شخصيات معدّة قياديًّا بالمعنى الشعبي وقادرة ماديًّا لتكوين عُصْبة شعبية قوية وجماعات ضغط محدودة في المحليات والإدارات الحكومية المختلفة وبعض الأجهزة السيادية وغيرها، مع تكرار هذا النموذج ليتخذ وضعًا مؤثرًا يخدم أي حراك محتمل.
ومن الناحية التجديدية للفكر المعارض أو الرافض أو للحكم الاستبدادي؛ فمن الضروري التركيز على الثغرات المجتمعية التي تظهر كنتيجة طبيعية لحالة التفسخ والتفكك الاجتماعي؛ بسبب الهشاشة المقصودة، والصراع الطبقي، وانتشار الفقر وما يتبعه من آفات وأمراض.
والأهم من ذلك هو رصد حالة التسخط والهجوم اللفظي والسخرية من رأس النظام شخصيًّا بما يسقط هيبته، بل ومن الحكومة والنظام كله، كمؤشرات وبدايات لحالة التململ ما قبل الحراك، فشيوع تلك الحالة من سقوط الهيبة هي مؤشر مهم للغاية لاحتمال حدوث الفورة الشعبية، التي ينبغي الاستعداد لتوجيهها فور اندلاعها بِناءً على تنبؤات النخبة وتصوراتها.
ويبقى من المهم مناقشة “نظريات التغيير الاجتماعي” وأيها أنسب لواقعنا وثقافتنا، وكيفية تحديد وصناعة “شخصية المركز” كما يسميها علماء الاجتماع؛ لصياغة نظرية متكاملة للحكم والتوجيه على وجه الإجمال الأيديولوجي لا التفصيل التنفيذي والذي لا يُكون إلا بعد التمكن من تسلم زمام القيادة.