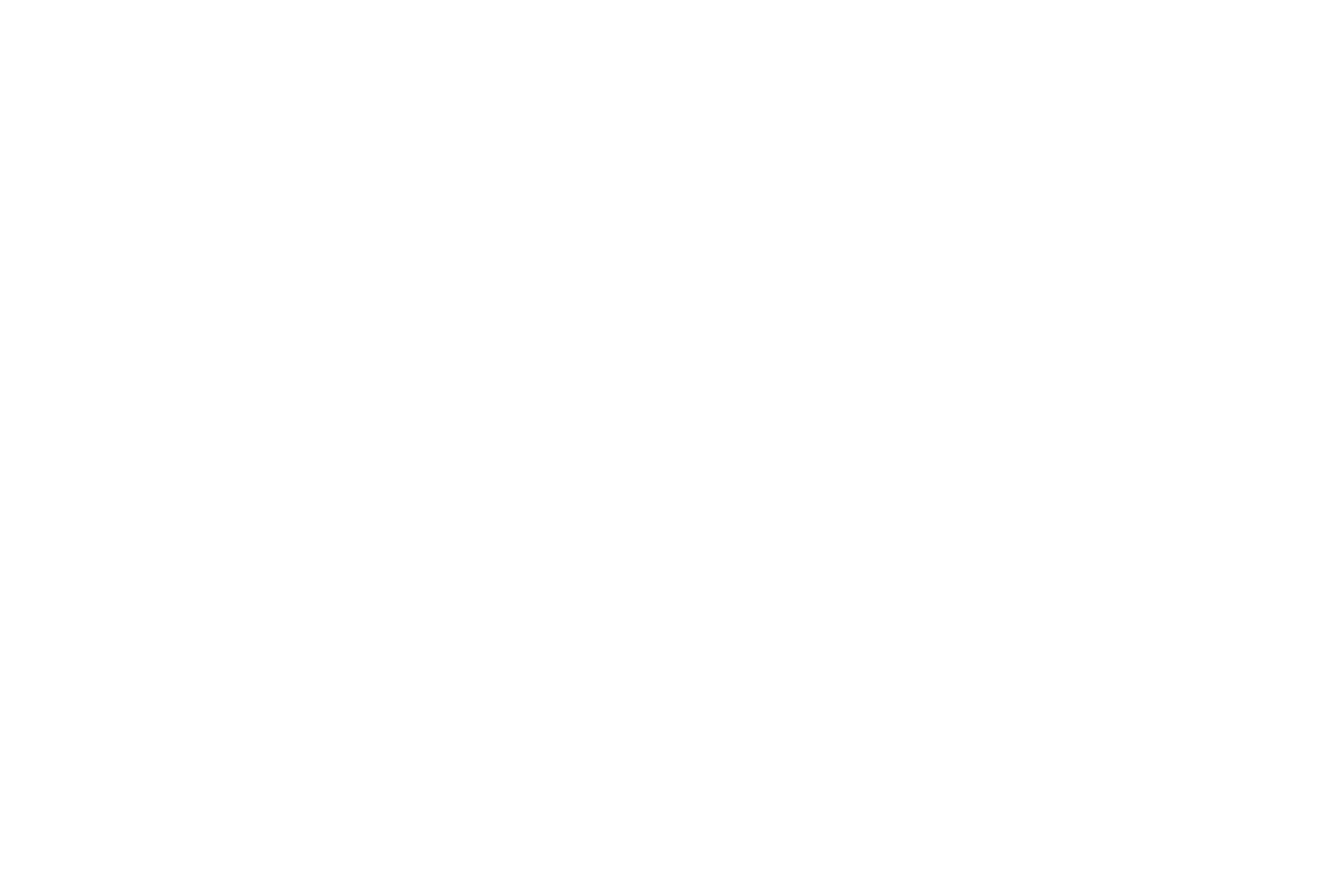وجه أوروبا القبيح
مع اشتعال أُتون الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إثر غزو الأولى للثانية عسكريًّا في 24 فبراير الماضي، ظهرت موجات من اللاجئين الأوكران الهاربين من ويلات الحرب قاصدين الدول المجاورة وخاصة بولندا ورومانيا. رافقت هذه الموجات مجموعات كبيرة من المقيمين الأجانب في أوكرانيا ممن لم يجدوا بُدًّا من السير لعبور الحدود مع الأوكرانيين طلبًا للنجاة.
وفي خضم هذه الأحداث، أطلت على العالم كله من شاشات الأخبار تصريحات وتعبيرات من مراسلي قنوات أجنبية وصحفيين ومسئولين أوروبيين، أعادت للأذهان مرة أخرى وجه أوروبا القبيح المنتفخ بالعنصرية والإقصاء وتعالي الذات الغربية ومركزية الأنا عند الرجل الأبيض. نذكر من هذه التصريحات[1]:
1- تصريح ديفيد ساكفاريليدزي، نائب المدعي العام الأوكراني السابق : “الأمر مؤثر للغاية بالنسبة لي لأنني أرى أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يُقتلون”.
2- تصريح تشارلي داجاتا، مراسل شبكة CBS الأمريكية : “هذه ليست العراق أو أفغانستان.. هذه مدينة أوروبية متحضرة نسبيًّا”.
3- مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية: ” ما هو مقنعٌ هو النظر إليهم، الطريقة التي يرتدون بها ملابسهم، هؤلاء أناس مزدهرون من الطبقة الوسطى، هؤلاء ليسوا لاجئين يحاولون الابتعاد عن الشرق الأوسط، أو شمال أفريقيا، إنهم يبدون مثل أي عائلة أوروبية كانت تعيش في البيت المجاور”.
4- مراسل بي اف ام تي من فرنسا: “نحن في القرن الحادي والعشرين، نحن في مدينة أوروبية ولدينا نيران صواريخ كروز كما لو كنا في العراق وأفغانستان، هل يمكنك أن تتخيل!”.
5- ديلي تيليجراف، بريطانيا: هذه المرة الحرب خاطئة لأن الناس يشبهوننا ولديهم حسابات على انستجرام ويشاهدون نت فيليكس.. ليس في بلد فقير ونائية.
6- اى تي في، بريطانيا: لقد حدث ما لا يمكن تصوره.. هذه ليست دولة نامية من العالم الثالث، هذه أوروبا!
7- تصريح كايلي كوبيلا، مراسلة NBC الأمريكية: “بصراحة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا، إنهم مسيحيون، إنهم بيض، إنهم مشابهون جدًّا لنا”.
8- تصريح كيريل بيتكوف رئيس الوزراء البلغاري: “إن هؤلاء أناس أذكياء ومتعلمون وبعضهم متخصصون في تكنولوجيا المعلومات وهم مؤهلون تأهيلًا عاليًا. هذه ليست موجة لاجئين اعتدنا عليها، حيث لا نعرف ماذا نفعل مع أناس لديهم ماض غامض، كأن يكونوا إرهابيين مثلًا”.
هذه التصريحات خرجت من أشخاص متنوعين ومن دول مختلفة، يجمعهم كونهم غربيين من أوروبا وأمريكا. وبقدر ما تبدو هذه التصريحات مفاجئة للكثيرين فإنها لم تكن المشهد الوحيد الدال على العنصرية الأوروبية واللاإنسانية في التعامل مع الآخر المختلف. فقد بدا واضحًا وشاهد الجميع مشاهد الإقصاء والتمييز بين الفارين من الحرب إلى الحدود البولندية والرومانية، حيث بادر الجيش الأوكراني وحرس الحدود في الدولتين لإدخال الأوكرانيين على حساب الجنسيات الأخرى من عرب وأفارقة وهنود. وهو المشهد الذي يعيد إلى أذهاننا مشاهد محاولات إغراق خفر السواحل اليوناني لمراكب السوريين الهاربين إلى أوروبا من جحيم الحرب السورية، وكذا تركهم على حدود الدول معرضين لمخاطر الهلاك والموت. أو حتى مشاهد انتزاع الأطفال السوريين من ذويهم في السويد وإيداعهم لدى أسرٍ أخرى.
هذا الذي نراه من تصريحات وتصرفات ليس جديدًا ولا مُحدثًا عند الأوروبيين، فهم أولياء العنصرية والإقصاء بحق. وهذه التوجهات لها جذورها العميقة الممتدة في تاريخهم وتاريخ أفكارهم، وهو ما نتعرض له فيما يلي.
أولًا: فكرة تفوق العرق الأبيض:
جاء إرساء قواعد نظرية تفوق العرق الأبيض الآري في أكمل صورها على يد أرتور دي جوبينو، الذي نشر كتابه الشهير عام 1853م بعنوان “مقال في عدم تساوي الأجناس”. وكان لآرائه وأفكاره أثرٌ كبير على الأفكار والمعتقدات السياسية والفلسفية الأوروبية. وقد انطوى مفهوم جوبينو عن العرق على نظام تراتبي حيث يظهر العرق الأبيض فيه بوضوح مستأثرًا بالجمال والذكاء والقوة، ومزايا أخرى متمثلة في اجتماعيته المتحضرة ونقاوته وتوسعه عن طريق الغزو، إلا أن هذه المزايا تضعف بسبب الاختلاط أو التصاهر مع دم أدنى، وهذا قد يؤدي إلى خراب الحضارة[2].
وشهدت نظرية جوبينو تطويرًا مستمرًّا على مدار تاريخ أوروبا، وبدأ الأوروبيون يستأثرون بالنظرية كلٌّ وفق عرقه ليؤكد تفوقه على الأعراق الأخرى. فجاء هوستن تشامبرلين ليؤكد تفوق العنصر التيوتوني للألمان، وادعى أن الحضارة الإغريقية وحضارة روما وإنشاء البابوية في روما وعصر النهضة في أوروبا والثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون كلها من إنتاج التيوتون. وقد استخدمت هذه النظرية في تبرير الأغراض النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، واعتنقها هتلر، واعتمد على دعوى تفوق الألمان العرقي في حروبه على الشعوب الأخرى وفي إبادته لليهود[3].
كما ظهرت أيضًا مدرسة فكرية قدم لها لابوج في فرنسا وأمون في ألمانيا، تفيد بتفوق الجنس الأشقر ذي الرأس الطويل. كما ظهر مذهب تفوق الجنس الأنجلوساكسوني في أمريكا، والنظرية الكلتية التي تطورت في فرنسا، وتؤكد هذه النظرية أن الجنس “الكلتي” له صفات جسدية ونفسية تجعل منه جنسًا متفوقًا على بقية الأجناس[4].
لعبت مذاهب التفوق العرقي دورًا هامًّا في السياسات العليا للدول، فطالما بررت هذه المذاهب مشاهد القسوة والدوافع غير الإنسانية. كما خدمت التوسع الأوروبي الاستعماري كسبب للاستعمار، وتخدم كذلك التوسع الإمبريالي الحديث. ولطالما ساقت هذه العنصرية إلى الحروب والصراعات. وبالرغم من أن معظم هذه النظريات تعرضت للنقض والتكذيب، إلا أننا لازلنا نرى لها آثارًا وذيوعًا في العالم الغربي. ولا زلنا نشاهد حتى الآن التفرقة العنصرية بين أصحاب البشرة البيضاء والسوداء في الولايات المتحدة (حادثة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة مثالًا). والتمييز بين الأوروبيين ومن سواهم من أصحاب الأعراق والألوان المغايرة.
يبدو إذًا أن مسألة إبراز تفوق جنس معين على غيره من الأجناس، ومحاولة تبرير هذا التفوق باستخدام الأساليب العلمية (علم الأنثروبولوجيا مثلًا)؛ مسألة متجذرة ومتأصلة في أعماق الفكر الأوروبي والغربي القديم والحديث.
ثانيًا: عنصرية ضاربة في الجذور:
كانت العنصرية الغربية فريدة في مداها وشمولها. ضاربة في جذور الفكر الغربي تجلت قديمًا جدًّا في أفكار أرسطو. فقد نادى أرسطو بنظرية أكد فيها أن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة، وجماعات أخرى تولد لكى تكون عبيدًا، وهى نظرية استخدمت فيما بعد لتبرير استرقاق الزنوج والهنود الحمر في أمريكا[5]. ولم تكتفِ بتسميم الثقافة الأوروبية بل نشرت الميكروب في جميع أنحاء العالم. ازدهرت المستوطنات الاستعمارية في العالم الجديد (في أمريكا الشمالية والجنوبية على السواء) بفضل إبادة السكان الأصليين وبفضل العمل العبودي الذي قام به جنس آخر من أفريقيا، وحتى الأرض الأفريقية ذاتها أصبحت مهدًا للمؤسسات العنصرية الأوروبية: أسواق العبيد الدولية، الدول الاستيطانية البيضاء، المزارع والمناجم التي يعمل فيها العبيد ويديرها البيض. ومع نهاية القرن التاسع عشر كان الأوروبيون والأمريكيون قد نقلوا آراءهم العنصرية إلى جزر المحيط الهادي والشرق الأقصى. وبمضي الوقت أفرزوا رؤى عنصرية تضع الصينيين واليابانيين والشرقيين في مستوى دون الإنسانية، ولم تكن هذه الرؤى إلا صيغة مبتسرة لنفس الأفكار القديمة عن السود والهنود الأمريكيين الأصليين[6].
نجد أيضًا أن العنصرية ثقافة أوروبية خالصة، حيث لم تكن هناك أي مؤشرات قوية – وفقًا لكافين رايلي- في الثقافة الأفريقية تدل على أن الأفارقة كانوا سيرغبون في استرقاق الأوروبيين وقهر الأمريكيين. فالثقافات الأفريقية بصفة عامة كانت أقل انشغالًا بالسلطة والإنتاجية من الثقافة الأوروبية. كما أن احتمال أن ينظر الأفريقيون إلى الأوروبيين على أنهم دون البشر أو مجرد موضوعات للاستغلال كان ضعيفًا، أما الأوروبيون فكانوا أكثر اهتمامًا بالغزو العسكري والسيطرة وأكثر ميلًا إلى التفكير في الإطار العنصري[7].
ومن منظور مقارن نجد أن هناك اختلافًا طفيفًا بين أوروبي الشمال وأوروبي الجنوب، وخاصة بين الأسبان والبرتغاليين (في شبه جزيرة أيبريا) والأوروبيين الشماليين ولا سيما البريطانيين. فقد كان الأسبان والبرتغاليون أقل عنصرية من غيرهم لأنهم عاشوا مع الأفارقة في شبه جزيرة أيبريا منذ الفتح الإسلامي عام 711م. فقد كان من المستحيل لمن عاش مع المسلمين في ذلك المكان ورأى ثقافة المسلمين أن يساوي بين السواد والتخلف. أما الإنجليز فقد فعلوا ذلك لأن جهلهم بالحضارة الأفريقية أو الإسلامية كان كاملًا أو يكاد في ذلك الوقت المبكر[8].
وهكذا سعى الغرب في إطار المركزية الغربية إلى تقسيم الثقافات إلى ثقافة عليا (ذاته الخاصة) وثقافة محلية (العالم غيره)، تقوم العلاقة بينهما على أساس نفي الاختلاف ورفض التفاعل للثقافة المسيطَر عليها، سواء بتدميرها أو تبخيس ذاتها أو نكرانها، واعتبارها موضوعا سالبًا يسوغ عقلًا للأنا الغربي الاعتداء على الآخر دونه. وبهذا تمكن الغرب من بلورة صورة عن ذاته كأَنَا مطلقة تفوق كل آخر، وبالتزامن معها فقد شكّل صورة ممسوخة عن الآخر ليطمس معالمها ويؤكد بهذا ذاته كمرجعية أحادية.
ختامًا، يمكن القول إن الرؤية الكلية الغربية قامت على ثنائية الأنا الغربي المتحضر/ الآخرالمتوحش، وازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، ولم تكن هذه الرؤية منظورًا مستحدثًا تلبسه الغرب في القرون الأخيرة، إنما كانت هذه الثنائية القائمة على العنصرية فكرة راسخة منذ المجتمعات القديمة، منذ عصور اليونان، لكنها كانت أقل حدة من صورتها الآن. وبناءًا على هذا نقول إن الحضارة الغربية تسوق لنا زورًا على أنها حضارة إنسانية عالمية، غير أنها في الواقع حضارة إقصائية لا تستوعب الجميع، بل تلفظ كل مختلف ولا تقبل التعدد ولا المساواة بالصورة التي تعرضها زيفًا للعالم.
[1] انظر: https://cutt.us/1NiFT.
[2] غريغوار منصور مرشو، نحن والآخر، دار الفكر، 2001، ص27.
[3] جوان كوماس، خرافات عن الأجناس، ترجمة: محمد رياض، مؤسسة هنداوي، 2012، ص ص 47-53.
[4] المصدر السابق، ص ص54-55.
[5] جوان كوماس، خرافات عن الأجناس، مصدر سابق، ص9.
[6] كافين رايلي، الغرب والعالم، القسم الثاني، سلسلة عالم المعرفة، 1986، ص87.
المصدر السابق، ص88.[7]
[8] المصدر السابق، ص99.