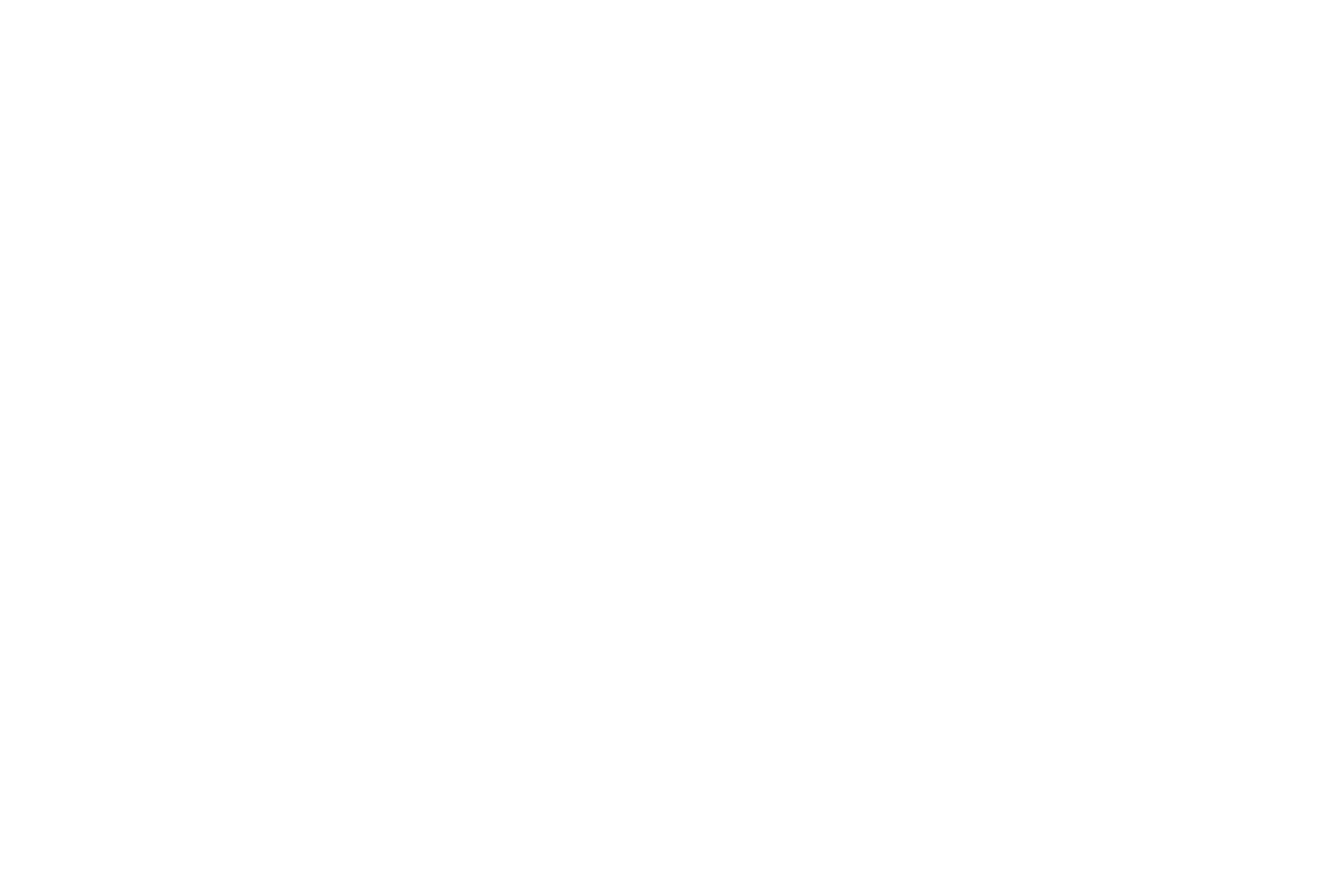انتهت جولة التصعيد الأخيرة بين “إسرائيل” وتنظيم الجهاد الإسلامي، والتي اندلعت شرارتها عقب قيام سلاح الجو “الإسرائيلي” باغتيال بهاء الدين أبو عطا، القائد العسكري لسرايا القدس في غزة، بالتزامن مع استهداف “أكرم العجوري”، أحد أبرز أعضاء المكتب السياسي للحركة، في دمشق، حيث استشهد نجله معاذ، ونجا القياديّ من الهجوم.
وبطبيعة الحال، شرع المحللون الفلسطينيون والباحثون العرب في تقييم هذه الجولة من التصعيد بعد انتهائها. ولكنّ الملاحَظ في تقييمات بعضهم بشكل واضح، هو تعمد الترويج لرواية انتصار الجهاد الإسلامي على “إسرائيل”، بالمخالفة لمعطيات المعركة، ونتائجها الحقيقية. وقد بدا ذلك جليًا عند بعض المحللين البارزين مثل د. صالح النعامي، ود. عدنان أبو عامر وغيرهما.
قد تكون هذه السّرديّة التي روّجها الإعلام الفلسطينيّ ملائمة لمطلب احتواء حالة ما بعد المعركة في السياق الفلسطيني الداخلي، وبالأخص في قطاع غزة. بل وقد تكون متسقة مع أدبيات الإعلام العسكري التي تولي اهتماما كبيرا بالروح المعنوية للمقاتلين، وتماسك الحاضنة الشعبية للمقاومة.. ولكن الباحثين قد تكون لهم نظرة أكثر موضوعيةً في سؤال التقييم. وهي مهمة لا تتعارض مع مطالب التطمين والاحتواء، لأن تلك النظرة البحثية لا يرتجى منها إلا استخلاص العبر، سعيًا إلى تعظيم المكاسب، وتفادي الخسائر مستقبلًا.
حرب العقول مجددًا
“حرب العقول”، هو المصطلح الذي وُلد أساسًا من رحم البيئات غير المتماثلة (مناطق التمرد)، للإشارة إلى أهميّة الجانب غير المرئي من هذه الصراعات التي تخوضها قوات نظامية ضد الجماعات “المارقة”، حيث يحيلنا المصطلح إلى مجالات أمن المعلومات، والحرب الإلكترونية، والحرب النفسية. ويعتبر قطاع غزة، المتاخم للحدود الجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ والحدود الشرقية لمصر، والذي يعجّ بالتنظيمات الإسلامية المسلحة، منطقة عمليات مشتعلة بهذا النوع من الحروب، خاصة في فترات الاستراحة من الحروب الطويلة وجولات التصعيد القصيرة.
في أوقات السلم، تقوم المقاومة بمهمات، مثل استخدام الفضاء الافتراضي لتجنيد العيون على الأرض، والحصول على معلومات عن “الجيش الإسرائيلي”. وفي أوقات الحرب، تهاجم المقاومة المواقع الإلكترونية العبرية، وتستخدم الفضائيات والهواتف العبريّة لبث رسائلها النفسية للمجتمع “الإسرائيلي”، حيث قصف “الجيش الإسرائيلي”وحدة السايبر التابعة للمقاومة جوًا، مايو/ آيار الماضي، مُسوّقًا إياه كانتصار عظيم.
وفي سياق ملتهب كهذا، تُعدّ حماية القيادات الميدانية للمقاومة، أولويةً قصوى، ينبغي العناية بها من قبل هذه القيادات نفسها أولا، ومن قبل الجهات المنوط بها تأمين الشخصيات المهمة والحفاظ على سرية المعلومات والمجال الأمني في القطاع. فعلى سبيل المثال، نجا محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، عام ٢٠١٤، من محاولة اغتيال محققة، قُتلت خلالها زوجته ونجله الرضيع، رغم أنه بمثابة “قائد مجهول الشكل” في القطاع، حيث لا تكاد توجد له صورٌ شخصية على وسائل الإعلام.
وترتبط أولوية تأمين القيادات الأمنية أيضاً بحقيقةٍ معروفة في علوم اجتماع المنظمات الأمنية، وهي أن القائد ليس فردًا، بقدر ما هو رمزيّة، تُكثف – بكفاءتها – هُويةَ المنظمة، وتحافظ – بوجودها – على استقرارها، خاصة إذا كانت المنظمة مغلقة، لا تحدد مسارات واضحة لتصعيد القيادات وتبادل السلطة، وتعمل في بيئة أمنية واجتماعية شديدة الاضطراب بالأساس. حيث يفتح التخلّص “المفاجئ” من قائد المنظمة مجالًا واسعًا لإمكانية اختراقها من أعلى، خلال فترة مؤقتة على الأقل، كما يتسبب في “صدمةٍ نفسية” لأعضاء المنظمة (القيادات الوسطى، والأفرع التنظيمية، والمقاتلين)، الذين يضطرون للعمل في وضع استثنائي، تحت وطأة مشاعر متناقضة، كالخوف، والغضب، والانتقام، بمعزل عن الهُوية الواضحة، والحمولة الشعورية المستقرة التي اعتادوا العمل من خلالها داخل المنظمة.
وبالنسبة لـ”أبو عطا”، فقد كان أحد أبرز قيادات “سرايا القدس” الميدانية في قطاع غزة، حيث حاولت “إسرائيل” اغتياله عام 2014 بالفعل، ثم أخذ يتلقى تهديدات مستمرة بالاغتيال منذ ذلك الحين، لذلك كان المفترض أنه على علم بوضعه في دائرة النار “الإسرائيلية”، خاصّة أنه كان مسؤولًا أيضًا عن جولات التصعيد الأخيرة، والتي مثلت إزعاجا شديدًا لـ”إسرائيل”. كما يُعتبر واحدًا من أبرز القيادات الميدانية المقربة من إيران في المنطقة، حيث وصفته صحيفة “جيروزاليم بوست” في أحد تقاريرها بأنه “العنصر الثالث الأكثر خطورةً على إسرائيل”، بعد قاسم سليماني، وحسن نصر الله.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا من المحللين الفلسطينيين، على رأسهم عدنان أبو عامر، قد حذروا فصائل المقاومة بالفعل من احتمالية عودة الكيان إلى “سياسة الاغتيالات”، وذلك في ضوء قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) المتعلقة بغزة، “والتي صُوّت عليها بالإجماع” مطلع نوفمبر/ تشرين الماضي.. ورغم كل ذلك، فقد اغتيل أبو عطا في مبنى سكني (فوق الأرض) خلال نفس الشهر، شرق حي الشجاعية. وتؤكد التقارير “الإسرائيلية” (روي بن يشاي) أن قرار اغتياله قد اتخذ قبل ذلك التاريخ، في غضون سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما هاجم الجهاد مؤتمرًا انتخابيًا لنتنياهو في”سديروت”، وهو ما يرجح رصده طول هذه المدة.
الرد المنتظر
عندما تتعرض المنظمة إلى خطر وجودي، على غرار محاولة المساس بالقائد، فإن رد الفعل المنتظر ينبغي أن يكون على مستوى الخطر والخسارة. وترتبط هذه القاعدة بمطلبين، الأول هو ردع الخصم عن المساس بالقيادات أصلا، (أو إثنائه عن ذلك مستقبلًا إذا تحقق الاغتيال)، والثاني، هو إعادة الاعتبار للمنظمة أمام عناصرها في السلّم التنظيمي، وتثبيت الحالة النفسية لهم، وتأمين تماسك الصورة الذهنية للمنظمة في أعينهم.
وبالنسبة للحالة الغزاوية، فقد أرست “كتائب القسام” عام 2015 قاعدة “الرؤوس بالرؤوس”، حينما بثت صورًا تظهر قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق، والمكلف بتشكيل الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة، “بيني غانتس”، في دائرة نيران أحد قناصيها المرابطين على الحدود. لم تستهدف القسّام القائد العسكري لاعتبارات أمنية وسياسية مفهومة، لكنها أرسلت رسالةً واضحة لا لبس فيها، بخصوص عيونها الاستخبارية، وجهوزيتها الميدانية، وقدرتها على الردع.
وفي جولاتٍ أخرى لم تمسّ فيها “إسرائيل” قياديا من المقاومة ولم تتجاوز “خطوطًا حمراء”، كانت سرايا القدس تصول وتجول في الميدان، وتنوع هجماتها ضد بنك الأهداف “الإسرائيلي”، برًا وجوًا، بالصاروخ، والقناصة، والنفق، والكورنيت، مُسببةً خسائر فادحة في الأرواح، بعدما تسلّت بقصف منطقة “ديمونا” النووية؛ كما حدث في مايو/ آيار الماضي. لذلك، كان المنتظر ردًا من جنس الاعتداء، باستهداف قيادي من الفئة المتوسطة في جيش الاحتلال، أو وضع أحد القيادات الكبرى تحت دائرة النار على الأقل؛ مع توسيع دائرة الهجمات، كمًا ونوعًا.
وبالفعل، بدأت “سرايا القدس” فور الاغتيال توسع مدى القصف الصاروخي، تمهيدًا لعملياتٍ أكثر خطورةً وأكثر تنوعًا، كما أكد قادتها الميدانيون على لسان “أبو حمزة” المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس؛ ولكن ما حدث فعليًا أن عناصر التنظيم كان يتم اصطيادهم عند فتحات الأنفاق، وأثناء إطلاق الصواريخ، وخلال محاولات اجتياز الحدود تباعًا، باستخدام الطائرات بدون طيار “الإسرائيلية”، وهو ما يشير إلى أن جهوزية جيش الاحتلال الذي رسم المشهد جيدًا، قوبلت باضطراب ميداني من قبل جماعة الجهاد، سبّبه، على الأرجح، اغتيال أبرز قيادات التنظيم، وغياب مؤازرة الطرف الأبرز عن المعركة: حماس.
كيف غابت حماس؟
طالما تعاملت “إسرائيل” مع التجاوزات الأمنية العابرة للحدود على طريقة وضع كل البيض في نفس السلة. فبغض النظر عن هُوية التنظيم الذي أطلق الصاروخ، يستهدف سلاح الجو “الإسرائيلي” المواقع والمقرات التابعة لحماس، كعقابٍ أبديّ لها على تولّي مسؤولية إدارة القطاع، وافتراضًا لتقاعسها عن ضبط التنظيمات الصغيرة، التي توكلها حماس بضرب “إسرائيل” نيابةً عنها.
هذه السياسة “الإسرائيلية” كانت ضوءًا أخضر لكل التنظيمات السلفية المتشددة التي تكفر حماس وتعتبرها خادمةً لسياسات الاحتلال، ولتلك التنظيمات التي تقف على الجانب المناقض وترى في قطاع غزة ملعبًا خلفيا للانتقام لإيران من الضربات التي تتلقاها في المناطق الآخرى المشتعلة، كالعراق وسوريا ولبنان؛ فكان الفريقان يخرقان الهدنات بإطلاق الصواريخ من الحين للآخر، فيما تتحمل حماس المسؤولية بطبيعة الحال.
وعلى قدر هذا الضرر الفادح كانت لهذه السياسة “الإسرائيلية” فوائدها؛ حيث كانت تُضرب الأمثال في اصطفاف معظم التنظيمات خلف حماس في وجه الاحتلال، خاصة “سرايا القدس” التي أطلقت عنوان “البنيان المرصوص” على ضرباتها ضد الاحتلال، مساندةً لشقيقتها الكبرى “كتائب القسام” التي أسمت معركتها بـ”العصف المأكول” ردًا على إطلاق الاحتلال عدوان “الجرف الصامد” يوليو/ تموز 2014. فكانت هذه الوقفة التاريخية حينها بمثابة اللبنة الأهم في إنجاز ما يُعرف بـ”الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة” حاليًا.
ولكن سياسة “إسرائيل” تغيرت خلال هذه الجولة، حيث نحّت حماسَ جانبا للمرة الأولى، وقالت إنها تستهدف القائد العسكري الذي كان يشرف على إشعال الحدود في أكثر من جولة منذ عام 2018 وحده، بينما تثمّن الهدنة مع حماس، مؤكدةً على لسان نتنياهو، أنها لن تعود إلى سياسة الاغتيالات؛ حيث أرادت “إسرائيل” إشاعة سردية شيطانية مفادها؛ أن حماس قد باعت شقيقتها الجهاد، بعد استقرار علاقتها مع تل أبيب، عبر بوابة إحدى الدول العربية، بموجب بعض التسهيلات المالية والإدارية.
يقوم التكتيك “الإسرائيلي” الجديد على ضرب العلاقة بين منظمتين مختلفتين نسبيًا، ولكن تربطهما علاقة توافق ضد عدو مشترك أكثر قوةً. وقد أعدت “إسرائيل” الظروف، وهذا التوقيت لهذه الجولة، حتى تفتك بحركة الجهاد في معركةٍ غير متكافئة، تكون حالة “المقاومة” نفسها فيها أكبر الخاسرين.
وأمام هذا المشهد، عجّت حينها مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الفلسطينيين المتسائلين عن غياب حماس عن نصرة شقيقتها الصغرى التي يستفرد الاحتلال بها، في ظل تأكيداتٍ من “سرايا القدس”، بعد كل بيان صادر عن “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة”، على خوض عناصرها المعركة بمفردهم. كما زكّت تصريحات بعض القيادات السياسية الفلسطينية حالةَ الفُرقة بين التنظيمين الأكبر في القطاع، خاصةً تصريحات زياد نخالة من الجهاد الإسلامي، وموسى أبو مرزوق من حماس، حيث عزا الأخير تقاعس حماس إلى عدم التنسيق المتبادل لخوض هذه الجولة؛ وهو ما يعني أن الطرفين قد ابتلعا الطُعم الصهيوني بالفعل.
أسطورة الحصار
ترتكز الرواية التي تُروج لانتصار الجهاد على دولة الاحتلال في الجولة الأخيرة على مقولة واحدة ثابتة لا تتغير، وهي تسبب الصواريخ التي أطلقتها غزة في توقف الحياة على الجانب الآخر، استنادًا إلى حقيقة تعطيل النشاطات المدنية مسافة 80 كم من الحدود لمدة يومين بعد التصعيد.
ولكن هذه المقولة، التي تشير إلى جزء من الحقيقة بطبيعة الحال، تغفل معرفة الجانب “الإسرائيلي” وكل المتابعين للشأن الفلسطيني لحقيقة امتلاك سرايا القدس مقذوفاتٍ صاروخية تغطي كامل الأراضي المحتلة تقريبا، منذ عام 2014، حينما قصفت حتى مدينة “الخضيرة” التي تبعد 110 كم عن الحدود بصواريخ برق.
وتتجاهل هذه المقولة أيضا حقيقة أن الاعتماد على هذه الصواريخ هو وليد حالة غزة والسياق الفلسطيني بشكل عام، حيث تركز هذه البقعة الجغرافيّة محدودة المساحة والمسيطر عليها من تنظيمات المقاومة، على المقذوفات (أرض/ أرض) رخيصة الثمن، محلية الصنع، لمواجهة التفوق الجوي “الإسرائيلي” القادر على الوصول إلى كل الأهداف داخل القطاع المحاصَر منذ 13 عاما، والممنوع عنه كلّ التقنيات التي قد تحدث خللا في معادلة القوة. وبينما تستطيع الطائرات إصابة أهدافها بدقة شديدة وقوة تفجيرية ضخمة، تعوّض المقاومة هذه المميزات بتقنية “الإغراق الصاروخي”. وعلى هذا الأساس، كان النقد الداخلي للجيش “الإسرائيلي” الذي قتل عائلة “السواركة” في غزة في قصف جوي، قيل في البداية إنه لقائد القوة الصاروخية لسرايا القدس.
ونظرًا لافتقاد الاحتلال لما يُعرف بـ”العمق الاستراتيجي”، وحرصه المبالغ على الحياة؛ فإنه يضطر خلال الحروب إلى تعطيل الحياة المدنية، في أماكن متنوعة تصل إلى نصف مساحة الكيان الصهيوني. وقد استمر هذا الأمر خلال معظم معركة العصف المأكول، التي تعتبر أطول حرب في تاريخ الصراع العربي/ “الإسرائيلي” حيث استغرقت ٥١ يومًا. فباستثناء أيام التهدئة، وخلال كل جولة تصعيد قصيرة تتم، تشرف ما تُسمى بــ “قيادة الجبهة الداخلية” على مغادرة المستوطنين منازلهم إلى الملاجئ، ونزوح من لا يسعهم الجنوب إلى الشمال والوسط.
وخلافا لما جرى في مايو/ آيار الماضي مثلا، عندما كانت الجهاد نفسها هي من تدير العمليات أمام حماس على الحدود، حيث قتل 5 مستوطنين قصفًا، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الواحدة والسبعين لتأسيس الدولة، ومهرجان “يورو فيجن” الغنائي الأوروبي؛ فإن الإغراق الصاروخي لم ينجح هذه المرة في تكبيد دولة الاحتلال أي خسائر في الأرواح، باستثناء بعض الإصابات بالهلع والسجحات أثناء الركض. وقد نجحت “القبة الحديدية” في اعتراض نسبةٍ عالية من هذه الصواريخ (تصل في بعض التقديرات إلى 90٪)، وهبط الباقي في منازل غادرها أصحابها، أو مناطق ميتة لا تغطيها القبة، كما استخدم الاحتلال منظومة إنذار جديدة تقسم الدولة إلى ١٧٠٠ منطقة إنذار، لتفادي أخطاء المنظومة القديمة.
الخُلاصة
استطاعت “إسرائيل” تسجيل نصر سياسيّ وعسكري خاطف لأول مرة، بعد عدة جولات متتالية تلقت خلالها هزائم واضحة، خاصة جولة مايو/ آيار الماضي التي أشعلتها المقاومة لاغتيال عنصرين من شباب المقاومة. ويرجع ذلك بوضوح إلى إمساكها بزمام المبادرة، وإعدادها الجيد من جهة، وإخفاق حركة الجهاد في تأمين قياداتها، وتأثرها باغتيال أبي عطا، وخوضها المعركة منفردةً بدون شقيقتها الكبرى من جهة أخرى.
بدت علامات الهزيمة واضحةً في “لغة” الشارع، الذي استخدم مصطلح “الاستفراد بالجهاد” بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم في خروجه لأول مرة للمطالبة بتوسيع رد المقاومة، بعد إقرار الهدنة المصرية الأممية، وهو الذي اعتاد على الاحتفاء بـ”النصر” في المهرجانات الشعبية بعد كل عدوان، رغم أعداد الضحايا التي كانت تسقط، والخسائر الميدانية، وتنصل الاحتلال من التفاهمات المبرمة على أساس توقف الحرب، ولكن كانت الاحتفالات لشعوره فقط باستبسال المقاومة للدفاع عن القطاع، وهو ما لم يجده هذه المرة. كما بدت على المستوى السياسي، في تمرير التهدئة، دون أي شروط تذكر تقريبًا.
وبالنسبة لحماس، فإنها ستحتاج إلى مزيد من الجهود لـ”جبر ضرر” علاقتها مع شقيقتها الصغرى (الجهاد) كما فعلت مؤخرا مع المتضررين من الحسم العسكري الذي نفذته عناصرها ضد حركة فتح عام 2006، حيث تعرض بعض وفد حماس لمناوشات وملاسنات كلامية حادة من قبل عناصر الجهاد خلال عزاء الشهيد “أبو عطا”، وهو مؤشر خطير بكلّ تأكيد.
وقد تضطر حماس إلى الدخول في مواجهة قريبة مع الاحتلال، بصورة منفردة، لتجاوز آثار هذا “الإسفين”، ويبدو أن إرهاصات جولة كهذه تتشكل سريعا الآن، حيث كشفت القسام أثناء التصعيد عن معلومات عسكرية جديدة تخص ملابسات إحدى عملياتها النوعية التي أشرف عليها أبو خالد (محمد الضيف) شخصيا ضد الاحتلال إبان عملية “حد السيف”، كما نسبت إليها المصادر “الإسرائيلية” قصف بئر السبع بعد التهدئة مباشرة، لإلغاء استضافة مباراة منتخب “الأرجنتين” الودية التي أقيمت في “إسرائيل”، بالإضافة إلى قصفها “سديروت” منذ يومين.
وقد تقوم حماس، خلال الأيام القليلة القادمة، بتدارك الصدمة سريعًا، وقلب الطاولة على الجميع، عبر تعميق مأزق نتنياهو السياسي، الذي يوشك على دخول السجن بعد تفعيل المدعي العام القانوني” مندلبليت” إجراءات التحقيق معه في قضايا فساد، من خلال بث مقطع مدته 10 ثوانٍ يتحدث خلاله أحد الجنود المأسورين منذ عام 2014، ليثبت كذب ادعاء نتنياهو بشأن مقتل الجنود المفقودين، ويبث الروح من جديد في قلوب الجماهير الفلسطينية التي تشعر بخيبة أمل واضحة من نتائج الجولة الأخيرة، خاصة في ظل تصعيد “إسرائيلي” متعلق برفض تسليم جثث الفلسطينيين الذين تقوم بقتلهم.
اضغط لتحميل الملف